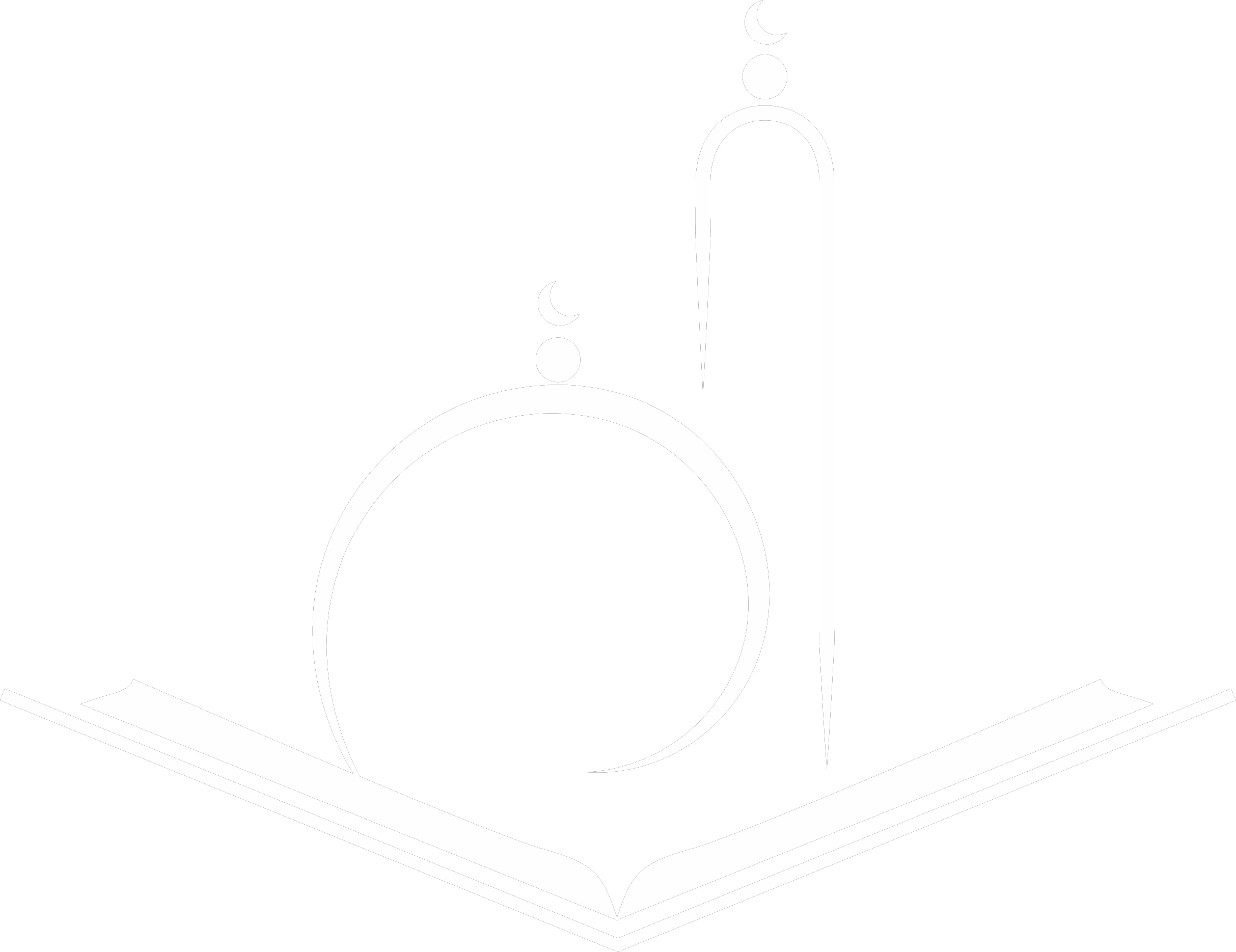
إعراب الآية 43 سورة الأعراف - ونـزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد
سورة الأعراف الآية رقم 43 : إعراب الدعاس
إعراب الآية 43 من سورة الأعراف - إعراب القرآن الكريم - سورة الأعراف : عدد الآيات 206 - - الصفحة 155 - الجزء 8.
﴿ وَنَزَعۡنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنۡ غِلّٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهِمُ ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ وَقَالُواْ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهۡتَدِيَ لَوۡلَآ أَنۡ هَدَىٰنَا ٱللَّهُۖ لَقَدۡ جَآءَتۡ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلۡحَقِّۖ وَنُودُوٓاْ أَن تِلۡكُمُ ٱلۡجَنَّةُ أُورِثۡتُمُوهَا بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ﴾
[ الأعراف: 43]
﴿ إعراب: ونـزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد ﴾
الصور البلاغية و المعاني الإعرابية للآية 43 - سورة الأعراف
﴿ تفسير التحرير و التنوير - الطاهر ابن عاشور ﴾
انتساق النّظم يقتضي أن تكون جملة : { تجري من تحتهم الأنهار } حالاً من الضّمير في قوله : { هم فيها خالدون } [ الأعراف : 42 ] ، وتكونَ جملة : { ونزعنا } مُعترضة بين جملة : { أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون } [ الأعراف : 42 ] ، وجملة : { وقالوا الحمد لله } إلخ ، اعترضاً بُيِّنَ به حال نفوسهم في المعاملة في الجنّة ، ليقابِل الاعتراض الذي أُدمِج في أثناءِ وصف عذاب أهل النّار ، والمبيّن به حال نفوسهم في المعاملة بقوله : { كلما دخلت أمة لعنت أختها } [ الأعراف : 38 ].
والتّعبير عن المستقبل بلفظ الماضي للتّنبيه على تحقّق وقوعه ، أي : وننزع ما في صدورهم من غِل ، وهو تعبير معروف في القرآن كقوله تعالى : { أتى أمر الله } [ النحل : 1 ].
والنّزْع حقيقته قلع الشّيء من موضعه وقد تقدّم عند قوله تعالى : { وتنزع الملك ممن تشاء } في آل عمران ( 26 ) ، ونَزْع الغِل من قلوب أهل الجنّة : هو إزالة ما كان في قلوبهم في الدّنيا من الغِلّ عند تلقي ما يسوء من الغَيْر ، بحيث طَهّر الله نفوسهم في حياتها الثّانية عن الانفعال بالخواطر الشرّية التي منها الغِلّ ، فزال ما كان في قلوبهم من غِلّ بعضهم من بعض في الدّنيا ، أي أزال ما كان حاصلاً من غلّ وأزال طباع الغلّ التي في النّفوس البشريّة بحيث لا يخطر في نفوسهم .
والغِلّ : الحقد والإحْنَة والضِغْن ، التي تحصل في النّفس عند إدراك ما يسوؤها من عمل غيرها ، وليس الحسد من الغِلّ بل هو إحساس باطني آخر .
وجملة : تجري من تحتهم الأنهار } في موضع الحال ، أي هم في أمكنة عالية تشرف على أنهار الجنّة .
وجملة : { وقالوا الحمد لله } معطوفة على جملة : { أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون } [ الأعراف : 42 ].
والتّعبير بالماضي مراد به المستقبل أيضاً كما في قوله : { ونزعنا } وهذا القول يحتمل أن يكونوا يقولونه في خاصتهم ونفوسهم ، على معنى التّقرب إلى الله بحمده ، ويحتمل أن يكونوا يقولونه بينهم في مجامعهم .
والإشارة في قولهم : { لهذا } إلى جميع ما هو حاضر من النّعيم في وقت ذلك الحمد ، والهداية له هي الإرشاد إلى أسبابه ، وهي الإيمان والعمل الصّالح ، كما دلّ عليه قوله : { والذين آمنوا وعملوا الصالحات } [ الأعراف : 42 ] ، وقال تعالى : { يهديهم ربهم بإيمانهم } [ يونس : 9 ] الآية ، وجعل الهداية لنفس النّعيم لأنّ الدّلالة على ما يوصل إلى الشّيء إنّما هي هداية لأجل ذلك الشّيء ، وتقدّم الكلام على فعل الهداية وتعديته في سورة الفاتحة ( 6 ).
والمراد بهَدْي الله تعالى إياهم إرساله محمّداً صلى الله عليه وسلم إليهم فأيقظهم من غفلتهم فاتَّبعوه ، ولم يعاندوا ، ولم يستكبروا ، ودلّ عليه قولهم : { لقد جاءت رسل ربنا بالحق } مع ما يسّر الله لهم من قبولهم الدّعوة وامتثالهم الأمر ، فإنّه من تمام المنّة المحمود عليها ، وهذا التّيسير هو الذي حُرّمه المكذّبون المستكبرون لأجل ابتدائهم بالتّكذيب والاستكبار ، دون النّر والاعتبار .
وجملة { وما كنا لنهتدي } في موضع الحال من الضّمير المنصوب ، أي هدانا في هذه الحال حال بعدنا عن الاهتداء ، وذلك ممّا يؤذن بكبر منّة الله تعالى عليهم ، وبتعظيم حمدهم وتجزيله ، ولذلك جاءوا بجملة الحمد مشتملة على أقصى ما تشتمل عليه من الخصائص التي تقدّم بيانها في سورة الفاتحة ( 6 ).
ودلّ قوله : { وما كنا لنهتدي } على بعد حالهم السّالفة عن الاهتداء ، كما أفاده نفي الكَون مع لام الجحود ، حسبما تقدّم عند قوله تعالى : { ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة } الآية في سورة آل عمران ( 79 ) ، فإنّهم كانوا منغمسين في ضلالات قديمة قد رسخت في أنفسهم ، فأمّا قادتهم فقد زيّنها الشّيطان لهم حتى اعتقدوها وسنّوها لمن بعدهم ، وأمّا دَهْمَاؤُهم وأخلافهم فقد رأوا قدوتهم على تلك الضّلالات . وتأصّلت فيهم ، فما كان من السّهل اهتداؤُهم ، لولا أنْ هداهم الله ببعثة الرّسل وسياستهم في دعوتهم ، وأن قذف في قلوبهم قبول الدّعوة .
ولذلك عقبوا تحميدهم وثناءهم على الله بقولهم : لقد جاءت رسل ربنا بالحقّ } فتلك جملة مستأنفة ، استئنافاً ابتدائياً ، لصدورها عن ابتهاج نفوسهم واغتباطهم بما جاءتهم به الرّسل ، فجعلوا يتذكّرون أسباب هدايتهم ويعتبرون بذلك ويغتبطون . تلذذاً بالتّكلّم به ، لأن تذكّر الأمر المحبوب والحديثَ عنه ممّا تلذّ به النّفوس ، مع قصد الثّناء على الرّسل .
وتأكيد الفعل بلام القسم وبقَدْ ، مع أنهم غير منكرين لمجيء الرسل : إما لأنّه كناية عن الإعجاب بمطابقة ما وعدهم به الرّسل من النّعيم لما وجدوه مثل قوله تعالى : { وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين } [ الزخرف : 71 ] وقول النّبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : « أعددت » . وإمّا لأنّهم أرادوا بقولهم هذا الثّناء على الرّسل والشّهادة بصدقهم جمعاً مع الثّناء على الله ، فأتَوا بالخبر في صورة الشّهادة المؤكّدة التي لا تردّد فيها .
وقرأ ابن عامر : { ما كنّا لنهتدي } بدون واو قبل ( ما ) وكذلك كتبت في المصحف الإمام الموجّه إلى الشّام ، وعلى هذه القراءة تكون هذه الجملة مفصولة عن التي قبلها ، على اعتبار كونها كالتّعليل للحمد ، والتّنويه بأنّه حمد عظيم على نعمة عظيمة ، كما تقدّم بيانه .
وجملة : { ونودوا } معطوفة على جملة : { وقالوا } فتكون حالاً أيضاً ، لأنّ هذا النّداء جواب لثنائهم ، يدلّ على قبول ما أثْنَوا به ، وعلى رضى الله عنهم ، والنّداء من قبل الله ، ولذلك بُني فعله إلى المجهول لظهور المقصود . والنّداء إعلان الخطاب ، وهو أصل حقيقته في اللّغة ، ويطلق النّداء غالباً على دعاء أحد ليقبل بذاته أو بفهمه لسماع كلام ، ولو لم يكن برفع صوت : { إذ نادى ربَّه نداء خفياً } [ مريم : 3 ] ولهذا المعنى حروف خاصة تدلّ عليه في العربيّه ، وتقدّم عند قوله تعالى : { وناداهما ربهما } في هذه السّورة ( 22 ).
و ( أنْ ) تفسير { لنودوا } ، لأنّ النّداء فيه معنى القول . والإشارة إلى الجنّة ب { تلكم } ، الذي حقّه أن يستعمل في المشار إليه البعيد ، مع أنّ الجنّة حاضرة بين يديهم ، لقصد رفعة شأنها وتعظيم المنّة بها .
والإرث حقيقته مصير مال الميت إلى أقرب النّاس إليه ، ويقال : أورثَ الميّت أقرباءه ماله ، بمعنى جعلهم يرثونه عنه ، لأنّه لما لم يصرفه عنهم بالوصيّة لغيره فقد تركه لهم ، ويطلق مجازاً على مصير شيء إلى حد بدون عوض ولا غصب تشبيهاً بإرث الميّت ، فمعنى قوله : { أورثتموها } أعطيتموها عطيّة هنيئة لا تعب فيها ولا منازعة .
والباء في قوله : { بما كنتم تعملون } سببيّة أي بسبب أعمالكم ، وهي الإيمان والعمل الصّالح ، وهذا الكلام ثناء عليهم بأنّ الله شكر لهم أعمالهم ، فأعطاهم هذا النّعيم الخالد لأجل أعمالهم ، وأنّهم لما عملوا ما عملوه من العمل ما كانوا ينوون بعملهم إلا السّلامة من غضب ربّهم وتطلبَ مرضاته شكراً له على نعمائه ، وما كانوا يمُتون بأن توصلهم أعمالهم إلى ما نالوه ، وذلك لا ينافي الطّمع في ثوابه والنّجاة من عقابه ، وقد دلّ على ذلك الجمعُ بين { أورثتموها } وبين باء السّببيّة .
فالإيراث دلّ على أنّها عطيّة بدون قصد تعاوُضضٍ ولا تعاقُد ، وأنّها فضلٌ محض من الله تعالى ، لأنّ إيمان العبد بربّه وطاعته إياه لا يوجب عقلاً ولا عدْلاً إلاّ نجاتَه من العقاب الذي من شأنه أن يترتّب على الكفران والعصيان ، وإلاّ حُصولَ رضى ربّه عنه ، ولا يوجب جزاء ولا عطاء ، لأنّ شكر المنعم واجب ، فهذا الجزاء وعظمته مجرّد فضل من الرّب على عبده شكراً لإيمانه به وطاعته ، ولكن لما كان سبب هذا الشّكر عند الرّب الشّاكر هو عمل عبده بما أمره به ، وقد تفضّل الله به فوعد به من قبللِ حصوله . فمن العجب قول المعتزلة بوجوب الثّواب عقلاً ، ولعلّهم أوقعهم فيه اشتباه حصول الثّواب بالسّلامة من العقاب ، مع أنّ الواسطة بين الحالين بيّنة لأولي الألباب . وهذا أحسن ممّا يطيل به أصحابنا معهم في الجواب .
وباء السّببيّة اقتضت الذي أعطاهم منازل الجنّة أراد به شكر أعمالهم وثوابها من غير قصد تعاوض ولا تقابل فجعلها كالشيء الذي استحقّه العامل عوضاً عن عمله فاستعار لها باء السّببيّة .
المصدر : إعراب : ونـزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد