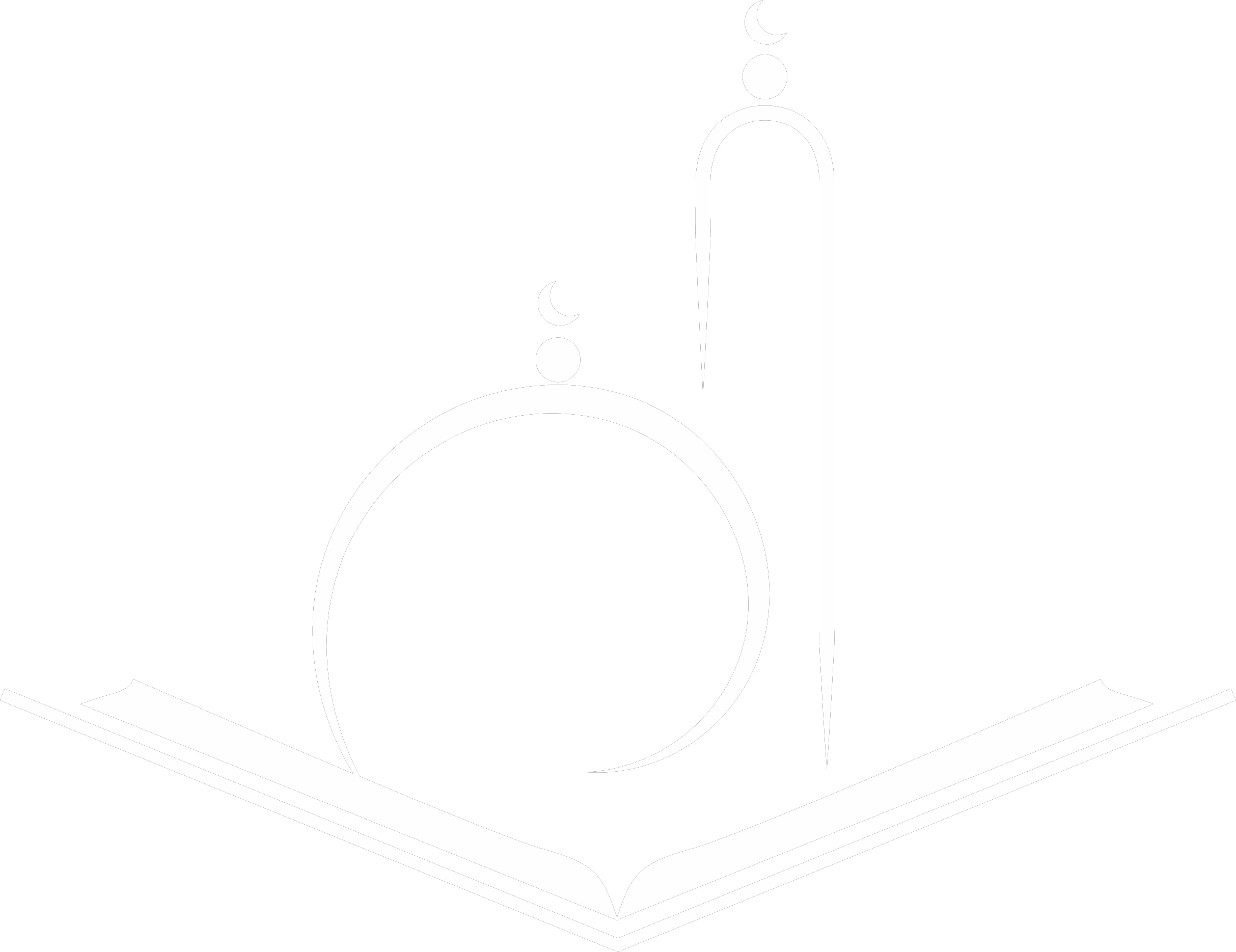
إعراب الآية 29 سورة التوبة - قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم
سورة التوبة الآية رقم 29 : إعراب الدعاس
إعراب الآية 29 من سورة التوبة - إعراب القرآن الكريم - سورة التوبة : عدد الآيات 129 - - الصفحة 191 - الجزء 10.
﴿ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ﴾
[ التوبة: 29]
﴿ إعراب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم ﴾
الصور البلاغية و المعاني الإعرابية للآية 29 - سورة التوبة
﴿ تفسير التحرير و التنوير - الطاهر ابن عاشور ﴾
الظاهر أن هذه الآية استيناف ابتدائي لا تتفرّع على التي قبلها ، فالكلام انتقال من غرض نبْذِ العهد مع المشركين وأحوال المعاملة بينهم وبين المسلمين إلى غرض المعاملة بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ، إذ كان الفريقان مسالمين المسلمين في أول بدء الإسلام ، وكانوا يحسبون أنّ في مدافعة المشركين للمسلمين ما يكفيهم أمر التصدّي للطعن في الإسلام وتلاشي أمره فلمّا أخذ الإسلام ينتشر في بلاد العرب يوماً فيوماً ، واستقلّ أمره بالمدينة ، ابتدأ بعض اليهود يظهر إحَنَه نحو المسلمين ، فنشأ النفاق بالمدينة وظاهرت قُريظة والنضير أهل الأحزاب لما غزوا المدينة فأذهبهم الله عنها .
ثم لمّا اكتمل نصر الإسلام بفتح مكّة والطائف وعمومه بلاد العرب بمجيء وفودهم مسلمين ، وامتد إلى تخوم البلاد الشامية ، أوجست نصارى العرب خيفة من تطرّقه إليهم ، ولم تغمض عين دولة الروم حامية نصارى العرب عن تداني بلاد الإسلام من بلادهم ، فأخذوا يستعدّون لحرب المسلمين بواسطة ملوك غسّان سادة بلاد الشام في ملك الروم . ففي «صحيح البخاري» عن عمر بن الخطاب أنّه قال : «كان لي صاحب من الأنصار إذا غبتُ أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن نتخوّف مَلِكاً من ملوك غسّان ذُكر لنا أنّه يريد أن يسير إلينا وأنّهم يُنْعِلون الخيلَ لغزونا فإذا صاحبي الأنصاري يدُقّ الباب فقال : افتح افتح . فقلت : أجَاء الغسّاني . قال : بل أشَدُّ من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه إلى آخر الحديث .
فلا جرم لمّا أمِن المسلمون بأس المشركين وأصبحوا في مأمن منهم ، أن يأخذوا الأهبة ليأمنوا بأس أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، فابتدأ ذلك بغزو خيبر وقريظة والنضير وقد هُزموا وكفَى الله المسلمين بأسَهم وأورثَهم أرضهم فلم يقع قتال معهم بعد ثم ثنّى بغزوة تبوك التي هي من مشارف الشام .
وعن مجاهد : أنّ هذه الآية نزلت في الأمر بغزوة تبوك فالمراد من الذين أوتوا الكتاب خصوص النصارى ، وهذا لا يلاقي ما تظافرت عليه الأخبار من أنّ السورة نزلت بعد تبوك .
و { مِن } بيانية وهي تُبَيِّن الموصولَ الذي قبلها .
وظاهر الآية أنّ القوم المأمور بقتالهم ثبتت لهم معاني الأفعال الثلاثة المتعاطفة في صلة الموصول ، وأنّ البيان الواقع بعد الصلة بقوله : { من الذين أوتوا الكتاب } راجع إلى الموصول باعتبار كونه صاحبَ تلك الصلات ، فيقتضي أنّ الفريق المأمور بقتاله فريق واحد ، انتفى عنهم الإيمانُ بالله واليوم الآخر ، وتحريمُ ما حرم الله ، والتديُّنُ بدين الحقّ . ولم يُعرف أهل الكتاب بأنّهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . فاليهود والنصارى مثبتون لوجود الله تعالى ومؤمنون بيوم الجزاء .
وبهذا الاعتبار تحيّر المفسرون في تفسير هذه الآية فلذلك تأوّلوها بأنّ اليهود والنصارى ، وإن أثبتوا وجود الله واليوم الآخر ، فقد وصفوا الله بصفات تنافي الإلهية فكأنّهم ما آمنوا به ، إذْ أثبتَ اليهود الجسمية لله تعالى وقالوا :
{ يد الله مغلولة } [ المائدة : 64 ]. وقال كثير منهم : { عزيز ابن الله } [ التوبة : 30 ].
وأثبت النصارى تعدّد الإله بالتثليث فقاربوا قول المشركين فهم أبعد من اليهود عن الإيمان الحقّ ، وأنّ قول الفريقين بإثبات اليوم الآخر قد ألصقوا به تخيّلات وأكذوبات تنافي حقيقة الجزاء : كقولهم : { لن تمسسّنا النار إلا أياماً معدودة } [ البقرة : 80 ] فكأنّهم لم يؤمنوا باليوم الآخر . وتكلّف المفسّرون لدفع ما يرد على تأويلهم هذا من المنوّع وذلك مَبسوط في تفسير الفخر وكلّه تعسّفات .
والذي أراه في تفسير هذه الآية أنّ المقصود الأهم منها قتال أهل الكتاب من النصارى كما علمتَ ولكنّها أدمجت معهم المشركين لئلا يتوهّم أحد أنّ الأمر بقتال أهل الكتاب يقتضي التفرّغ لقتالهم ومتاركة قتال المشركين .
فالمقصود من الآية هو الصفة الثالثة { ولا يدينون دين الحق }.
وأمّا قوله : { الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر } إلى قوله { ورسوله } فإدماج . فليس المقصود اقتصار القتال على من اجتمعت فيهم الصفات الأربع بل كل الصفة المقصودة هي التي أردفت بالتبيين بقوله : { من الذين أوتوا الكتاب } وما عداها إدماج وتأكيد لما مضى ، فالمشركون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون شيئاً ممّا حرم الله ورسوله لأنّهم لا شريعة لهم فليس عندهم حلال وحرام ولا يدينون دين الحق وهو الإسلام وأما اليهود والنصارى فيؤمنون بالله واليوم الآخر ويحرَمون ما حرّم الله في دينهم ولكنّهم لا يدينون دين الحقّ وهو الإسلام ويلحق بهم المجوس فقد كانت هذه الأديان هي الغالبة على أمممِ المعروففِ من العالم يومئذٍ ، فقد كانت الروم نصارى ، وكان في العرب النصارى في بلاد الشام وطي وكلب وقضاعة وتغلب وبَكر ، وكان المجوس ببلاد الفرس وكان فرق من المجوس في القبائل التي تتبع ملوك الفرس من تميم وبَكر والبحرين ، وكانت اليهود في خيبر وقريظة والنضير وأشتات في بلاد اليمن وقد توفّرت في أصحاب هذه الأديان من أسباب الأمر بقتالهم ما أومأ إليه اختيار طريق الموصولية لتعريفهم بتلك الصلات لأنّ الموصولية أمكن طريق في اللغة لحكاية أحوال كفرهم .
ولا تحسبنّ أنّ عطف جمل على جملة الصلة يقتضي لزوم اجتماع تلك الصلات لكلّ ما صدق عليه اسم الموصول ، فإن الواو لا تقيد إلاّ مطلق الجمع في الحكم فإنّ اسم الموصول قد يكون مراداً به واحد فيكون كالمعهود باللام ، وقد يكون المراد به جنساً أو أجناساً ممّا يثبت له معنى الصلة أو الصلات ، عَلى أنّ حرف العطف نائب عن العامل فهو بمنزلة إعادة اسم الموصول سواء وقع الاقتصار على حرف العطف كما في هذه الآية ، أم جمع بين حرف العطف وإعادة اسم الموصول بعد حرف العطف كما في قوله تعالى :
{ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً والذين يبيتون لربّهم سجّداً وقياماً ، والذين يقولون ربّنا اصرف عنّا عذاب جهنّم إنّ عذابها كان غراماً إنّها ساءت مستقراً ومقاماً ، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر } [ الفرقان : 63 68 ] فقد عطفت فيها ثمانية أسماء موصولة على اسم الموصول ولم يقتض ذلك أنّ كلّ موصول مختصّ المَاصْدَق على طائفة خاصّة بل العبرةِ بالاتّصاف بمضمون إحدى تلك الصلات جميعها بالأولى ، والتعويل في مثل هذا على القرائن .
وقوله : { من الذين أوتوا الكتاب } بيان لأقرب صلة منه وهي صلة { ولا يدينون دين الحق } والأصل في البيان أن يكون بلصق المبين لأنّ البيان نظير البدل المطابق وليس هذا من فروع مسألة الصفة ونحوها الواردة بعد جمل متعاطفة مفرد وليس بياناً لجملة الصلة على أنّ القرينة تردّه إلى مردّه . وفائدة ذكره التنديد عليهم بأنّهم أوتوا الكتاب ولم يدينوا دين الحقّ الذي جاء به كتابهم ، وإنّما دانوا بما حرفوا منه ، ومَا أنكروا منه ، وما ألصقوا به ، ولو دانوا دين الحق لاتّبعوا الإسلام ، لأنّ كتابهم الذي أوتوه أوصاهم باتّباع النبي الآتي من بعد { وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدّق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله تبغون } [ آل عمران : 81 83 ].
وقوله : { ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله }. بمعنى لا يجعلون حراماً ما حرّمه الله فإنّ مادة فعَّل تستعمل في جعل المفعول متّصفاً بمصدر الفعل ، فيفيد قوله : { ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله } أنّهم يجعلونه غير حرام والمراد أنّهم يجعلونه مباحاً . والمقصود من هذا تشنيع حالهم وإثارة كراهيتهم لهم بأنّهم يستبيحون ما حرّمه الله على عباده ولمّا كان ما حرمه الله قبيحاً منكراً لقوله تعالى : { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } [ الأعراف : 157 ] لا جرم أنّ الذين يستبيحونه دلّوا على فساد عقولهم فكانوا أهلاً لردعهم عن باطلهم على أنّ ما حرّم الله ورسوله شامل لكليات الشريعة الضروريات كحفظ النفس والنسب والمال والعرض والمشركون لا يحرّمون ذلك .
والمراد ( برسوله ) محمد صلى الله عليه وسلم كما هو متعارف القرآن ولو أريد غيره من الرسل لقال ورسله لأنّ الله ما حرّم على لسان رسوله إلاّ ما هو حقيق بالتحريم .
وعلى هذا التفسير تكون هذه الآية تهيئة للمسلمين لأنّ يغزوا الروم والفرس وما بقي من قبائِل العرب الذين يستظلّون بنصر إحدى هاتين الأمّتين الذينَ تأخر إسلامهم مثل قضاعة وتغلب بتخوم الشَّام حتّى يؤمنوا أو يعطوا الجزية .
و { حتّى } غاية للقتال ، أي يستمرّ قتالكم إيّاهم إلى أن يعطوا الجزية .
وضمير { يعطوا } عائِد إلى { الذين أوتوا الكتاب }.
والجِزية اسم لمال يعطيه رجال قوم جزاء على الإبقاء بالحياة أو على الإقرار بالأرض ، بنيتْ على وزن اسم الهيئة ، ولا مناسبة في اعتبار الهيئة هنا ، فلذلك كان الظاهر . هذا الاسم أنّه معرب عن كلمة ( كِزْيَت ) بالفارسية بمعنى الخراج نقله المفسّرون عن الخوارزمي ، ولم أقف على هذه الكلمة في كلام العرب في الجاهلية ولم يعرج عليها الراغب في «مفردات القرآن» . ولم يذكروها في «مُعَرَّب القرآن» لوقوع التردّد في ذلك لأنّهم وجدوا مادّة الاشتقاق العربي صالحة فيها ولا شكّ أنّها كانت معروفة المعنى للذين نزل القرآن بينهم ولذلك عُرّفت في هذه الآية .
وقوله : { عن يد } تأكيد لمعنى { يعطوا } للتنصيص على الإعطاء و { عن } فيه للمجاوزة . أي يدفعوها بأيديهم ولا يقبل منهم إرسالها ولا الحوالة فيها ، ومحلّ المجرور الحال من الجزية . والمراد يَد المعطي أي يعطوها غير ممتنعين ولا منازعين في إعطائها وهذا كقول العرب «أعطى بيده» إذا انقاد .
وجملة { وهم صاغرون } حال من ضمير يعطوا .
والصاغر اسم فاعل من صَغر بكسر الغين صَغَراً بالتحريك وصَغَاراً . إذا ذلّ ، وتقدّم ذكر الصغار في قوله تعالى : { سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله } في سورة الأنعام ( 124 ) ، أي وهم أذلاّء وهذه حال لازمة لإعطاء الجزية عن يد : والمقصود منه تعظيم أمر الحكم الإسلامي ، وتحقير أهل الكفر ليكون ذلك ترغيباً لهم في الانخلاع عن دينهم الباطل واتّباعهم دين الإسلام . وقد دلّت هذه الآية على أخذ الجزية من المجوس لأنهم أهل كتاب ونقل عن ابن المنذر : لا أعلم خلافاً في أنّ الجزية تؤخذ منهم ، وخالف ابنُ وهب من أصحاب مالك في أخذ الجزية من مجوس العرب . وقال لا تقبل منهم جزية ولا بدّ من القتل أو الإسلام كما دلت الآية على أخذ الجزية من نصارى العرب ، دون مشركي العرب : لأنّ حكم قتالهم مضى في الآيات السالفة ولم يتعرّض فيها إلى الجزية بل كانت نهاية الأمر فيها قوله : { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلّوا سبيلهم } [ التوبة : 5 ] وقوله { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم } [ التوبة : 11 ] وقوله { ويتوب الله على من يشاء } [ التوبة : 15 ]. ولأنّهم لو أخذت منهم الجزية لاقتضى ذلك إقرارهم في ديارهم لأنّ الله لم يشرع إجلاءهم عن ديارهم وذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر : إعراب : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم