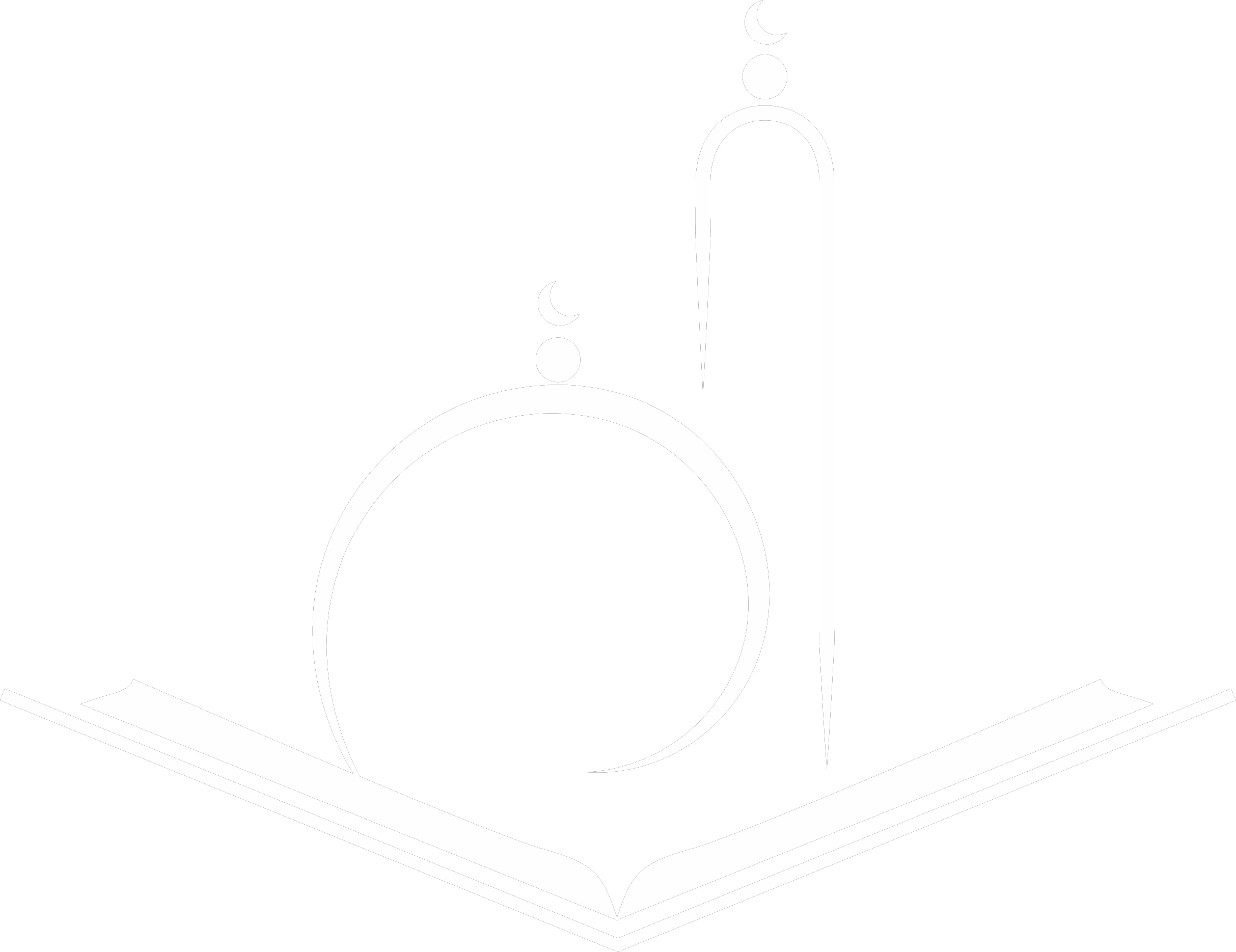
إعراب الآية 155 سورة الأعراف - واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو
سورة الأعراف الآية رقم 155 : إعراب الدعاس
إعراب الآية 155 من سورة الأعراف - إعراب القرآن الكريم - سورة الأعراف : عدد الآيات 206 - - الصفحة 169 - الجزء 9.
﴿ وَٱخۡتَارَ مُوسَىٰ قَوۡمَهُۥ سَبۡعِينَ رَجُلٗا لِّمِيقَٰتِنَاۖ فَلَمَّآ أَخَذَتۡهُمُ ٱلرَّجۡفَةُ قَالَ رَبِّ لَوۡ شِئۡتَ أَهۡلَكۡتَهُم مِّن قَبۡلُ وَإِيَّٰيَۖ أَتُهۡلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآۖ إِنۡ هِيَ إِلَّا فِتۡنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهۡدِي مَن تَشَآءُۖ أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَاۖ وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡغَٰفِرِينَ ﴾
[ الأعراف: 155]
﴿ إعراب: واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو ﴾
الصور البلاغية و المعاني الإعرابية للآية 155 - سورة الأعراف
﴿ تفسير التحرير و التنوير - الطاهر ابن عاشور ﴾
عطفت جملة { واختار موسى } على جملة : { واتخذ قوم موسى } [ الأعراف : 148 ] عطَف القصة على القصة : لأن هذه القصة أيضاً من مواقع الموعظة والعبرة بين العبَر المأخوذة من قصة موسى مع بني إسرائيل ، فإن في هذه عبرة بعظمة الله تعالى ورحمته ، ودعاء موسى بما فيه جُماع الخيرات والبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وملاك شريعته .
والاختيار تمييز المرغوب من بين ما هو مخلوط من مرغوب وضده ، وهو زنة افتعال من الخير صيغ الفعل من غير دلالة على مطاوعة لفعل ( خار ).
وقوله : { سبعين رجلا } بدل من { قَوْمَه } بدلَ بعض من كل ، وقيل إنما نُصب قوَمه على حذف حرف الجر ، والتقدير : اختار من قومه ، قالوا وحذْفُ الجار من المتعلق الذي هو في رتبة المفعول الثاني شائِع في ثلاثة أفعال : اختار ، واستغفر وأمر ، ومنه أمْرُتك الخير وعلى هذا يكون قوله : { سبعين } مفعولاً أول . وأيّاً مَّا كان فبناء نظم الكلام على ذكر القوم ابتداء دون الاقتصار على سبعين رجلاً اقتضاه حال الإيجاز في الحكاية ، وهو من مقاصد القرآن .
وهذا الاختيار وقع عندما أمره الله بالمجيىء للمناجاة التي تقدم ذكرها في قوله تعالى : { وواعدنا موسى ثلاثين ليلة } [ الأعراف : 142 ] الآية ، فقد جاء في التوراة في الإصحاح الرابع والعشرين من سفر الخروج : إن الله أمر موسى أن يصعد طور سينا هو وهارون و ( ناداب ) و ( أبيهو ) و ( يشوع ) وسبعون من شيوخ بني إسرائيل ويكون شيوخ بني إسرائيل في مكان معين من الجبل ويتقد موسى حتى يدخل في السحاب ليسمع كلام الله وأن الله لما تجلى للجبل ارتجف الجبل ومكث موسى أربعين يوماً . وجاء في الإصحاح الثاني والثلاثين والذي يعده ، بعدَ ذكر عبادتهم العجل وكسر الألواح ، أن الله أمر موسى بأن ينحت لوحين من حجر مثل الأولين ليكتب عليهما الكلمات العشر المكتوبة على اللوحين المنكسرين وأن يصعد إلى طور سينا وذكرتْ صفة صعود تقارب الصفة التي في الإصحاح الرابع والعشرين ، وأن الله قال لموسى من أخطأ أمحُوه من كتابي ، وأن موسى سجد لله تعالى واستغفر لقومه قلة امتثالهم وقال فإن عفرْتَ خطيئتهم وإلا فامحُني من كتابك . وجاء في الإصحاح التاسع من سفر التثنية : أن موسى لما صعد الطور في المناجاة الثانية صام أربعين يوماً وأربعين ليلة لا يأكل طعاماً ولا يشرب ماء استغفاراً لخطيئة قومه وطلباً للعفو عنهم .
فتبين مما في التوراة أن الله جعل لموسى ميقاتين للمناجاة ، وأنه اختار سبعين رجلاً للمناجاة الأولى ولم تَذْكر اختيارهم للمناجاة الثانية ، ولما كانت المناجاة الثانية كالتكملة للأولى تعيّن أن موسى استصحب معه السبعين المختارين ، ولذلك وقعت فيها الرجفة مثل المرة الأولى ، ولم يذكر القرآن أن الرجفة أخذتهم في المرة الأولى ، وإنما ذكر أن موسى خَرَّ صعقاً ، ويتعين أن يكون السبعون قد أصابهم ما أصاب موسى لأنهم كانوا في الجبل أيضاً ، وذكر الرجفة في المرة الثانية ولم تذكرها التوراة .
والضمير في أخذتهم الرجفة للسبعين . فالظاهر أن المراد في هذه الآية هو حكاية حال ميقات المناجاة الثانية التي وقع فيها الاستغفار لقومه ، وأن الرجفة المحكية هنا رجفة أخذتهم مثل الرجفة التي أخذتهم في المناجاة الأولى ، لأن الرجفة تكون من تجلي أثر عظيم من آثار الصفات الإلهية كما تقدم ، فإن قول موسى { اتهلكنا بما فعل السفهاء منا } يؤذن بأنه يعني به عبادتهم العجل ، وحضورَهم ذلك . وسكوتهم ، وهي المعنيُ بقوله : { إن هي إلا فتنتك } وقد خشي موسى أن تلك الرجفة مقدمة عذاب كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يخشى الريح أن يكون مبدأ عذاب .
ويجوز أن يكون ذلك في المناجاة الأولى وأن قوله : { بما فعل السفهاء منا } يعني به ما صدر من بني إسرائيل من التصلب قبل المناجاة ، كقولهم { لن نصبر على طعام واحد } [ البقرة : 61 ] ، وسؤالهم رؤية الله تعالى . لكن الظاهر أن مثل ذلك لا يطلق عليه ( فَعَل ) في قوله : { بما فعل السفهاء منا }. والحاصل أن موضع العبرة في هذه القصة هو التوقي من غضب الله ، وخوف بطشه ، ومقامُ الرسل من الخشية ، ودعاء موسى ، إلخ .
وقد صيغ نظم الكلام في قوله : { فلما أخذتهم الرجفة } على نحو ما صيغ عليه قوله : { ولما رجع موسى إلى قومه غضبانَ أسفا } [ الأعراف : 150 ] كما تقدم .
والأخذ مجاز في الإصابة الشديدة المتمكنة تمكن الآخذ من المأخوذ .
و ( لو ) في قوله : { لو شئت أهلكتهم } يجوز أن تكون مستعملة في التمني وهو معنى مجازي ناشىء من معنى الامتناع الذي هو معنى ( لو ) الأصلي ومنه قول المثل ( لو ذات سوار لطمتني ) إذ تقدير الجواب . لو لطمتني لكان أهون علي ، وقد صرح بالجواب في الآية وهو { شئت أهلكتهم } أي ليتك أردت إهلاكهم أي السبعين الذين معه . فجملة أهلكتهم بدل اشتمال من جملة { شئت } من قبل خطيئة القوم التي تسبب عنها الرجوع إلى المناجاة .
وعلى هذا التقدير في ( لو ) لا يكون ، في قوله { أهلكتهم } حذف اللام التي من شأنها أن تقترن بجواب ( لو ) وإنما قال : { أهلكتهم } وإياي ولم يقل : أهلكتنا ، للتفرقة بين الإهلاكين لأن إهلاك السبعين لأجل سكوتهم على عبادة العجل ، وإهلاك موسى ، قد يكون لأجل أن لا يشهد هلاك القوم ، قال تعالى :
{ فلما جاء أمرنا نجينا هوداً } [ هود : 58 ] الآية ونظائرها كثيرة ، وقد خشي موسى أن الله يهلك جميع القوم بتلك الرجفة لأن سائر القوم أجدر بالإهلاك من السبعين ، وقد أشارت التوراة إلى هذا في الإصحاح «فرجع موسى إلى الله وقال إن الشعب قد أخطأ خطيئة عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة فان غفرت لهم خطيئتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت . فقال الله لموسى من أخطأ إليّ أمحوه من كتابي» فالمحو من الكتاب هو محو تقدير الله له الحياةَ محوَ غضب ، وهو المحكي في الآية بقوله { لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا } وقد خشي موسى أن تكون تلك الرجفة إمارة غضب ومقدمة إهلاك عقوبة على عبادتهم العجل ، فلذلك قال { اتهلكنا بما فعل السفهاء منا } فالسفهاء هم الذين عبدوا العجل وسمي شركهم سفهاً؛ لأنه شرك مشوب بخسة عقل إذ جعلوا صورة صنعوها بأنفسهم إلهاً لهم .
ويجوز أن يكون حرف ( لو ) مستعملاً في معناه الأصلي : من امتناع جوابه لامتناع شرطه ، فيتجه أن يتساءل عن موجب حذف اللام من جواب ( لو ) ولم يقل : لأهلكتهم مع أن الغالب في جوابها الماضي المثبت أن يقترن باللام فحذف اللام هنا لنكتة أن التلازم بين شرط لو وجوابها هنا قوي لظهور أن الإهلاك من فعل الله وحده فهو كقوله تعالى : { لو نشاء جعلناه أجاجاً } سورة الواقعة ( 70 ) وسيأتي بيانه . ويكون المعنى اعترافاً بمنة العفو عنهم فيما سبق ، وتمهيداً للتعريض بطلب العفو عنهم الآن ، وهو المقصود من قوله { أتهلكنا بما فعل السفهاء } أي أنك لم تشأ إهلاكهم حين تلبسوا بعبادة العجل فلا تهلكهم الآن .
والاستفهام في قوله : { أتهلكنا } مستعمل في التفجع أي : أخشى ذلك ، لأن القوم استحقوا العذاب ويخشى أن يشمل عذابُ الله من كان مع القوم المستحقين وإن لم يشاركهم في سبب العذاب ، كما قال : { واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة } [ الأنفال : 25 ] وفي حديث أم سلمة أنها قالت : " يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبثُ " وفي حديث آخر ، " ثم يحشرون على نياتهم " وقد خشي موسى سوء الظنة لنفسه ولأخيه وللبراء من قومه أن يُظنهم الأمم التي يبلغها خبرهم أنهم مجرمون .
وإنما جمع الضمير في قوله : { أتهلكنا } لأن هذا الإهلاك هو الإهلاك المتوقع من استمرار الرجفة ، وتوقعه واحد في زمن واحد ، بخلاف الإهلاك المتقدم ذكره فسببه مختلف فناسب توزيع مفعوله .
وجملة : { أتهلكنا } مستأنفة على طريقة تقطيع كلام الحزين الخائف السائل . وكذلك جملة : { إن هي إلا فتنتك } وجملة { أنت ولينا }.
وضمير { إن هي } راجع إلى ما فعل السفهاء لأن ما صْدقَ ما فعل السفهاء هو الفتنة ، والمعنى : ليست الفتنةُ الحاصلة بعبادة العجل إلا فتنة منك ، أي من تقديرك وخلْق أسباببِ حدوثها ، مثل سخافة عقول القوم ، وإعجابهم بأصنام الكنعانيين ، وعيبة موسى ، وليننِ هارون ، وخشيته من القوم ، وخشية شيوخ إسرائيل من عامتهم ، وغير ذلك مما يعلمه الله وأيقن موسى به إيقاناً إجمالياً .
والخبر في قوله : { إن هي إلا فتنتك } الآية : مستعمل في إنشاء التمجيد بسعة العلم والقدرة ، والتعريض بطلب استبقائهم وهدايتهم ، وليس مستعملاً في الاعتذار لقومه بقرينة قوله : { تضل بها من تشاء } الذي هو في موضع الحال من { فتنتك } فالإضلال بها حال من أحْوالها .
ثم عرَّض بطلب الهداية لهم بقوله : { وتهدي من تشاء } والمجرور في قوله { بها } متعلق بفعل { تضل } وحده ولا يتنازعه معه فعل { تهدي } لأن الفتنة لا تكون سبب هداية بقرينة تسميتها فتنة ، فمن قدر في التفسير : وتهدي بها أو نحوه ، فقد غفل .
والباء : إما للملابسة ، أي تضل من تشاء ملابساً لها ، وإما للسببية ، أي تضل بسبب تلك الفتنة ، فهي من جهة فتنة ، ومن جهة سبب ضلال .
والفتنة ما يقع به اضطراب الأحوال ، ومرجها ، وتشتت البال ، وقد مضى تفسيرها عند قوله تعالى : { وما يعلّمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة } في سورة البقرة ( 102 ). وقوله : { وحسبوا أن لا تكون فتنة } في سورة العقود ( 71 ) وقوله : { ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين } في سورة الأنعام ( 23 ).
والقصد من جملة : { أنت ولينا } الاعتراف بالانقطاع لعبادة الله تعالى ، تمهيداً لمطلب المغفرة والرحمة ، لأن شأن الولي أن يرحم مولاه وينصره .
والولي : الذي له وَلاية على أحد ، والوَلايةِ حلف أو عتق يقتضي النصرة والإعانة ، فإن كان من جانبين متكافئين فكلا المتعاقدين يقال له مَولى ، وإن كان أحد الجانبين أقوى قيل للقوي ( ولي ) وللضعيف ( مَولى ) وإذ قد كانت الولاية غير قابلة للتعدد ، لأن المرء لا يتولى غيرَ مواليه ، كان قوله : { أنتَ ولينا } مقتضياً عدم الانتصار بغير الله . وفي صريحه صيغة قصر .
والتفريع عن الولاية في قوله : { فاغفر لنا } تفريع كلام على كلام وليس المراد أن الولي يتعين عليه الغفران .
وقدم المغفرة على الرحمة لأن المغفرة سبب لرحمات كثيرة ، فإن المغفرة تنهية لغضب الله المترتب على الذنب ، فإذا انتهى الغضب تسنى أن يخلفه الرضا . والرضا يقتضي الإحسان .
و { وخيرُ الغافرين } الذي يغفر كثيراً ، وقد تقدم قريب منه في قوله تعالى : { بل الله مولاكم وهو خير الناصرين } في سورة آل عمران ( 150 ).
وإنما عطف جملة : { وأنت خير الغافرين } لأنه خبر في معنى طلب المغفرة العظيمة ، فعطف على الدعاء ، كانه قيل : فاغفر لنا وارحمنا واغفر لنا جميع ذنوبنا ، لأن الزيادة في المغفرة من آثار الرحمة .
المصدر : إعراب : واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو