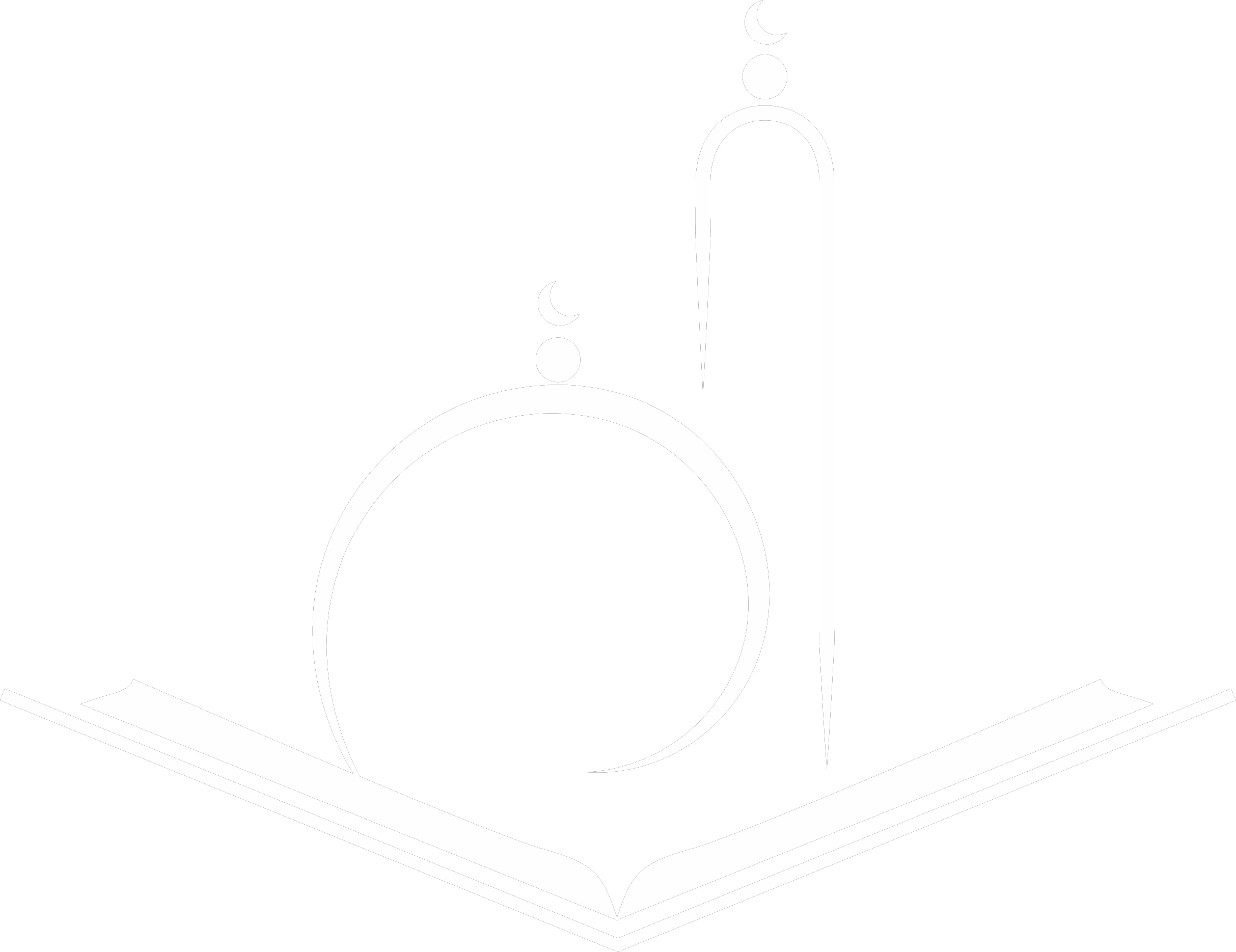
إعراب الآية 12 سورة الأنعام - قل لمن ما في السموات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة
سورة الأنعام الآية رقم 12 : إعراب الدعاس
إعراب الآية 12 من سورة الأنعام - إعراب القرآن الكريم - سورة الأنعام : عدد الآيات 165 - - الصفحة 129 - الجزء 7.
﴿ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ قُل لِّلَّهِۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفۡسِهِ ٱلرَّحۡمَةَۚ لَيَجۡمَعَنَّكُمۡ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ لَا رَيۡبَ فِيهِۚ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ﴾
[ الأنعام: 12]
﴿ إعراب: قل لمن ما في السموات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ﴾
الصور البلاغية و المعاني الإعرابية للآية 12 - سورة الأنعام
﴿ تفسير التحرير و التنوير - الطاهر ابن عاشور ﴾
جملة { قل لمن ما في السماوات والأرض } تكرير في مقام الاستدلال ، فإنّ هذا الاستدلال تضمّن استفهاماً تقريرياً ، والتقرير من مقتضيان التكرير ، لذلك لم تعطف الجملة . ويجوز أن يجعل تصدير هذا الكلام بالأمر بأن يقوله مقصوداً به الاهتمام بما بعد فعل الأمر بالقول على الوجه الذي سنبيّنه عند قوله تعالى : { قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة } في هذه السورة [ 40 ]. والاستفهام مستعمل مجازاً في التقرير . والتقرير هنا مراد به لازم معناه ، وهو تبكيت المشركين وإلجاؤهم إلى الإقرار بما يفضي إلى إبطال معتقدهم الشركَ ، فهو مستعمل في معناه الكنائي مع معناه الصريح ، والمقصود هو المعنى الكنائي .
ولكونه مراداً به الإلجاء إلى الإقرار كان الجواب عنه بما يريده السائل من إقرار المسؤول محقّقاً لا محيص عنه ، إذ لا سبيل إلى الجحد فيه أو المغالطة ، فلذلك لم ينتظر السائل جوابهم وبادرهم الجواب عنه بنفسه بقوله : لله } تبكيتاً لهم ، لأنّ الكلام مسوق مساق إبلاغ الحجّة مقدّرة فيه محاورة وليس هو محاورة حقيقية . وهذا من أسلوب الكلام الصادر من متكلّم واحد . فهؤلاء القوم المقدّر إلجاؤهم إلى الجواب سواء أنصفوا فأقرّوا حقّيّة الجواب أم أنكروا وكابروا فقد حصل المقصود من دمغهم بالحجّة . وهذا أسلوب متّبع في القرآن ، فتارة لا يذكر جواب منهم كما هنا ، وكما في قوله تعالى : { قل من ربّ السماوات والأرض قل الله } [ الرعد : 16 ] ، وقوله : { قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى قوله قل الله } [ الأنعام : 91 ] ، وتارة يذكر ما سيجيبون به بعد ذكر السؤال منسوباً إليهم أنّهم يجيبون به ثم ينتقل إلى ما يترتّب عليه من توبيخ ونحوه ، كقوله تعالى : { قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكّرون إلى قوله قل فأنّى تسحرون } [ المؤمنون : 84 89 ].
وابتدىء بإبطال أعظم ضلالهم . وهو ضلال الإشراك . وأدمج معه ضلال إنكارهم البعث المبتدأ به السورة بعد أن انتقل من ذلك إلى الإنذار الناشىء عن تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك لمّا كان دليل الوحدانية السالف دالاً على خلق السماوات والأرض وأحوالها بالصراحة ، وعلى عبودية الموجودات التي تشملها بالالتزام ، ذكر في هذه الآية تلك العبودية بالصراحة فقال : { قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله }.
وقوله : { لله } خبر مبتدأ محذوف دلّ عليه { ما في السماوات }.الخ . ويقدّر المبتدأ مؤخّراً عن الخبر على وزان السؤال لأنّ المقصود إفادة الحصر .
واللام في قوله : { لله } للملك؛ دلّت على عبودية الناس لله دون غيره ، وتستلزم أنّ العبد صائر إلى مالكه لا محالة ، وفي ذلك تقرير لدليل البعث السابق المبني على إثبات العبودية بحقّ الخلق . ولا سبب للعبوديّة أحقّ وأعظم من الخالقية ، ويستتبع هذا الاستدلالُ الإنذار بغضبه على من أشرك معه .
وهذا استدلال على المشركين بأنّ غير الله ليس أهلاً للإلهيّة ، لأنّ غير الله لا يملك ما في السماوات وما في الأرض إذ ملك ذلك لخالق ذلك . وهو تمهيد لقوله بعده { ليجمعنّكم إلى يوم القيامة } ، لأنّ مالك الأشياء لا يهمل محاسبتها .
وجملة : { كتب على نفسه الرحمة } معترضة ، وهي من المقول الذي أمر الرسول بأن يقوله . وفي هذا الاعتراض معان :
أحدها : أنّ ما بعده لمّا كان مشعراً بإنذار بوعيد قُدّم له التذكير بأنّه رحيم بعبيده عساهم يتوبون ويقلعون عن عنادهم ، على نحو قوله تعالى : { كتب ربّكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنّه غفور رحيم } [ الأنعام : 54 ] ، والشرك بالله أعظم سوءٍ وأشدّ تلبّساً بجهالة .
والثاني : أنّ الإخبار بأنّ لله ما في السماوات وما في الأرض يثير سؤال سائل عن عدم تعجيل أخذهم على شركهم بمن هم مِلكه . فالكافر يقول : لو كان ما تقولون صدقاً لعجّل لنا العذاب ، والمؤمن يستبطىء تأخير عقابهم ، فكان قوله : { كتب على نفسه الرحمة } جواباً لكلا الفريقين بأنّه تفضّل بالرحمة ، فمنها رحمة كاملة : وهذه رحمته بعباده الصالحين ، ومنها رحمة موقّتة وهي رحمة الإمهال والإملاء للعصاة والضّالّين .
والثالث : أنّ ما في قوله : { قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله } من التمهيد لما في جملة { ليجمعنّكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه } من الوعيد والوعد .
ذُكرت رحمة الله تعريضاً ببشارة المؤمنين وبتهديد المشركين .
الرابع : أنّ فيه إيماء إلى أنّ الله قد نجّى أمّة الدعوة المحمدية من عذاب الاستئصال الذي عذّب به الأمم المكذّبةَ رسلها من قبل ، وذلك ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ جعله رحمة للعالمين في سائر أحواله بحكم قوله تعالى : { وما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين } [ الأنبياء : 107 ] ، وإذ أراد تكثير تابعيه فلذلك لم يقض على مكذّبيه قضاء عاجلاً بل أمهلهم وأملى لهم ليخرج منهم من يؤمن به ، كما رجا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لمّا قالوا : { اللهمّ إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم } [ الأنفال : 32 ] قال الله تعالى { وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم } [ الأنفال : 33 ]. وقد حصل ما رجاه رسول الله فلم يلبث من بقي من المشركين أن آمنوا بالله ورسوله بعد فتح مكة ودخلوا في دين الله أفواجاً ، وأيّد الله بهم بعد ذلك دينه ورسوله ونشروا كلمة الإسلام في آفاق الأرض . وإذ قد قدّر الله تعالى أن يكون هذا الدين خاتمة الأديان كان من الحكمة إمهال المعاندين له والجاحدين ، لأنّ الله لو استأصلهم في أول ظهور الدين لأتى على من حوتْه مكة من مشرك ومسلم ، ثم يحشرون على نيّاتهم ، كما ورد في الحديث لمّا قالت أمّ سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
" أنهلك وفينا الصالحون ، قال : نعم ، إذا كثر الخبث ثم يحشرون على نيّاتهم " فلو كان ذلك في وقت ظهور الإسلام لارتفع بذلك هذا الدين فلم يحصل المقصود من جعله خاتمة الأديان . وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا نزل عليه { قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم } فقال : { أعوذ بسبحات وجهك الكريم }.
ومعنى { كتب } تعلّقت إرادته ، بأن جعل رحمته الموصوف بها بالذات متعلّقة تعلّقاً عامّاً مطّرداً بالنسبة إلى المخلوقات وإن كان خاصّاً بالنسبة إلى الأزمان والجهات . فلما كان ذلك مطّرداً شبّهت إرادته بالإلزام ، فاستعير لها فعل ( كتب ) الذي هو حقيقة في الإيجاب ، والقرينة هي مقام الإلهية ، أو جعَل ذلك على نفسه لأنّ أحداً لا يُلزم نفسه بشيء إلاّ اختياراً وإلاّ فإنّ غيره يُلزمه . والمقصود أنّ ذلك لا يتخلّف كالأمر الواجب المكتوب ، فإنّهم كانوا إذا أرادوا تأكيد وعد أو عهد كتبوه ، كما قال الحارث بن حلّزة :
واذكروا حلف ذي المجاز وما قدّم فيه العهود والكفلاء
حذر الجور والتطاخي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء
فالرحمة هنا مصدر ، أي كتب على نفسه أن يرحم ، وليس المراد الصفة ، أي كتب على نفسه الاتّصاف بالرحمة ، أي بكونه رحيماً ، لأنّ الرحمة صفة ذاتية لله تعالى واجبة له ، والواجب العقلي لا تتعلّق به الإرادة ، إلاّ إذا جعلنا { كتب } مستعملاً في تمجّز آخر ، وهو تشبيه الوجوب الذاتي بالأمر المحتّم المفروض ، والقرينة هي هي إلاّ أنّ المعنى الأول أظهر في الامتنان ، وفي المقصود من شمول الرحمة للعبيد المعرضين عن حقّ شكره والمشركين له في ملكه غيره .
وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا قضى الله تعالى الخلق كتب كتاباً فوضعه عنده فوق العرش " إنّ رحمتي سَبَقَتْ غضبي "
وجملة { ليجمعنّكم إلى يوم القيامة } واقعة موقع النتيجة من الدليل والمسبّب من السبب ، فإنّه لمّا أبطلت أهلية أصنامهم للإلهية ومحّضت وحدانية الله بالإلهية بطلت إحالتهم البعث بشبهة تفّرق أجزاء الأجساد أو انعدامها .
ولام القسم ونون التوكيد أفادا تحقيق الوعيد . والمراد بالجمع استقصاء متفرّق جميع الناس أفراداً وأجزاءاً متفرّقة . وتعديته ب { إلى } لتضمينه معنى السوق . وقد تقدّم القول في نظيره عند قوله تعالى : { الله لا إله إلاّ هو ليجمعنّكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه } في سورة [ النساء 87 ].
وضمير الخطاب في قوله : ليجمعنّكم } مراد به خصوص المحجوجين من المشركين ، لأنّهم المقصود من هذا القول من أوله؛ فيكون نِذارة لهم وتهديداً وجواباً عن أقلّ ما يحتمل من سؤال ينشأ عن قوله : { كتب على نفسه الرحمة } كما تقدّم .
وجملة { الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون } الأظهر عندي أنّها متفرّعة على جملة { ليجمعنّكم إلى يوم القيامة } وأنّ الفاء من قوله : { فهم لا يؤمنون } للتفريع والسببية .
وأصل التركيب : فأنتم لا تؤمنون لأنّكم خسرتم أنفسكم في يوم القيامة؛ فعدل عن الضمير إلى الموصول لإفادة الصلة أنّهم خسروا أنفسهم بسبب عدم إيمانهم . وجعل { الذين خسروا أنفسهم } خبرَ مبتدأ محذوف . والتقدير : أنتم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون . ونظم الكلام على هذا الوجه أدعى لإسماعهم ، وبهذا التقدير يستغنى عن سؤال «الكشاف» عن صحّة ترتّب عدم الإيمان على خسران أنفسهم مع أنّ الأمر بالعكس .
وقيل : { الذين خسروا أنفسهم } مبتدأ ، وجملة : { فهم لا يؤمنون } خبره ، وقرن بالفاء لأنّ الموصول تضمّن معنى الشرط على نحو قوله تعالى : { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم } [ النساء : 15 ]. وأشرب الموصول معنى الشرط ليفيد شموله كلّ من اتّصف بمضمون الصلة ، ويفيد تعليق حصول مضمون جملة الخبر المنزّل منزلة جواب الشرط على حصول مضمون الصلة المنزّلة منزلة جملة الشرط ، فيفيد أنّ ذلك مستمرّ الارتباط والتعليل في جميع أزمنة المستقبل التي يتحقّق فيها معنى الصلة . فقد حصل في هذه الجملة من الخصوصيات البلاغية ما لا يوجد مثله في غير الكلام المعجز .
ومعنى : { خسروا أنفسهم } أضاعوها كما يضيّع التاجر رأس ماله ، فالخسران مستعار لإضاعة ما شأنه أن يكون سبب نفع . فمعنى { خسروا أنفسهم } عدموا فائدة الانتفاع بما ينتفع به الناس من أنفسهم وهو العقل والتفكير ، فإنّه حركة النفس في المعقولات لمعرفة حقائق الأمور . وذلك أنّهم لمّا أعرضوا عن التدبّر في صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أضاعوا عن أنفسهم أنفع سبب للفوز في العاجل والآجل ، فكان ذلك سبب أن لا يؤمنوا بالله والرسول واليوم الآخر . فعدم الإيمان مسبّب عن حرمانهم الانتفاع بأفضل نافع . ويتسبّب عن عدم الإيمان خسران آخر ، وهو خسران الفوز في الدنيا بالسلامة من العذاب ، وفي الآخرة بالنجاة من النار ، وذلك يقال له خسران ولا يقال له خسران الأنفس . وقد أشار إلى الخسرانين قوله تعالى : { أولئك الذين خسروا أنفسهم وضلّ عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنّهم في الآخرة هم الأخسرون } [ هود : 21 ، 22 ].
المصدر : إعراب : قل لمن ما في السموات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة